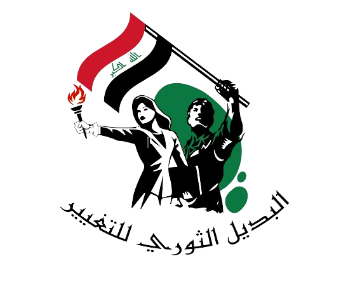إسرائيل تُروّج لأكاذيب لم يعد يُصدّقها أحد!؟
كتب البروفيسور المتقاعد وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية والخبير في النظرية الديمقراطية الشعبوية والسياسة الأمريكية “ديفيد ريتشي” مقالاً في “هآرتس” يحمل العنوان أعلاه، استهله بالقول: “نحن ندين الأكاذيب الكبرى التي روّجها طغاة الماضي في أوروبا، لكننا نحكي لأنفسنا كذبة كبرى، ننشرها ونعيد تأكيدها مرارًا وتكرارًا.. أقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الشهر الماضي، أن الاحتلال الإسرائيلي في المناطق، بما فيه من إنشاء للمستوطنات، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وردًا على ذلك القرار، أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن (الشعب اليهودي ليس مُحتلًا في أرضه) وأن (ليس في مقدور أي قرار إفترائيّ في لاهاي تشويه هذه الحقيقة التاريخية.”، وأضاف “يشكل هذا الرد استمرارًا وتكرارًا لـ “كذبة كبرى” ـ كذبة فظّة جدًا، لكن المستمعين لها يصدّقونها. الشخص الذي وضع هذا التعريف كان هتلر، بالذات: “في الكذبة الكبيرة ثمة صدق ما، دائمًا”، كتب في كتابه “كفاحي”، “لأن الجماهير من عامة الشعب… يقعون بسهولة أكبر في شِباك الكذبة الكبيرة، بالمقارنة مع الكذبة الصغيرة، لأنهم هم بأنفسهم غالبًا ما يروون أكاذيب صغيرة في شؤون صغيرة، لكنهم يخجلون من نشر الأكاذيب على نطاق واسع.”؟!
وتابع قائلاً: “نحن نستنكر، بالطبع، تلك الأكاذيب الكبيرة التي رواها طغاة الماضي في أوروبا، من أمثال هتلر، ستالين، موسوليني أو فرانكو، كما نرفض أيضًا أولئك الذين يُعتبَرون في أيامنا هذه كذابين عصريين من أمثال بوتين، أوربان أو ترامب الذي شجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في العام 2021، بزعم أن الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية قد “سُرق” منه.” واستدرك “لكن بالرغم من ذلك، كثيرون من بيننا هنا في إسرائيل يروون لأنفسهم، ولنا، أكاذيب كبيرة، ينشرونها بين الآخرين ثم يسمعونها وهي تُروى من قبَل كذّابين رفيعين، مثل نتنياهو الذي هو، من هذه الناحية، ليس مفكّرًا يسعى إلى إنشاء مجموعة خطيرة من المؤمنين التابعين به، وإنما هو أشبه بانتهازي تسلّقي ينضم إلى أغلبية قائمة تؤمن بالكذبة الكبيرة إياها، مسبقًا. أما الكذبة الكبيرة هذه فهي: نحن لسنا احتلالًا. نحن لسنا مُحتلّين.. صحيح أن وصف ما نرويه لأنفسنا بأنه “كذبة كبيرة” هو طريقة غير مهذبة لوصف حقيقة أننا لا نود التحدث عمّا نرتكبه بحق الفلسطينيين. لكن ربما كان الأجدر بنا أن نبدأ باستخدام هذه التسمية لكي نزعزع أنفسنا بطريقة تجعلنا، أولًا، نرى الأمر الذي نختار تجاهله والتهرب من مواجهته، وثانيًا، نتعامل مع الانعكاسات الهائلة لهذا التجاهل على السياسات القومية التي تعتمدها إسرائيل، وربما على مصيرها هي أيضًا.. نحن نقرّ هذه الكذبة ونكرّسها من خلال ترديدها وتكرارها، مرارًا وتكرارًا، على غرار ما فعل نتنياهو في رده على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي مثلًا؛ أو من خلال تجاهل الاحتلال ومحاولة إخفائه من السجال الجماهيري العام، وكأنّ ما لا نتحدث عنه يصبح غير قائم، غير موجود.”؟!
وختم مقالته بالقول: “في العام 2022، أرسى مستوطنون من شاكلة سموتريتش، بن غفير، روتمان وستروك هذه الكذبة الكبرى في الخطوط التأسيسية العريضة للحكومة الجديدة، من خلال جزمهم بأنّ (الشعب اليهودي هو صاحب الحق الحصري وغير القابل للاستئناف في كل مناطق أرض إسرائيل)، وهو ما يعني أن المناطق هي مُلك لنا بأمرٍ إلهي، فليس ثمة احتلال ولا استيطان ولا أبارتهايد ولا اضطهاد، ولا حتى جرائم حرب..أعضاء الائتلاف في الهيئة العامة للكنيست، في كانون الأول 2022. كرّسوا الكذبة الكبرى في الخطوط التأسيسية العريضة للحكومة، وأعضاء الائتلاف في الهيئة العامة للكنيست، في كانون الأول 2022. كرّسوا الكذبة الكبرى في الخطوط التأسيسية العريضة. منذ 7 تشرين الأول، أصبح الانعكاس الأساس لكذبتنا الكبيرة هذه هو الادعاء بأننا نخوض (حربًا وجودية) مقابل حركة حماس، حرب استقلال ثانية ضد أعداء لدودين حاولوا القضاء علينا في ذاك السبت المُرعِب وسيحالون ذلك مرة أخرى إنْ لم نُبِدْهم تمامًا.. لكنّ الحقيقة هي أن هؤلاء الأعداء هاجمونا بهدف وضع الاحتلال المستمر منذ 56 عامًا على جدول الأعمال الدولي، وقمنا نحن بالرد ليس من أجل منع القضاء على دولة إسرائيل، وإنما من أجل صيانة هذا الاحتلال وتكريسه.. إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن كثيرين من بيننا لا يفهمون لماذا يتم اعتبارنا منبوذين. على سبيل المثال، لماذا يتظاهر ضدّنا كل هؤلاء الطلاب في الجامعات المختلفة في دول عديدة في العالم؟ إنهم لا يفهمون الحقائق ـ أننا لم نفعل أي شيء سيء (في النهاية، ليس هنالك احتلال بالطبع) وأننا، في نهاية المطاف، نمارس حقنا السيادي في الدفاع عن النفس؟ حتى الأمم المتحدة تقول إن الدفاع عن النفس هو أمر شرعي ومشروع، أليس كذلك.. أي نوع من “الصراع” بيننا وبين الفلسطينيين؟ ما الذي فعلوه ليبرر حقيقية أننا، بعد مضي 55 سنة على الحرب التي وقفوا فيها متفرجين، لا نزال نستولي على أراضيهم بالقوة وعليهم أن يمنحونا جزءًا منها، على الأقل، قبل أن نقبل بالمغادرة والعودة إلى بيتنا.. في هذه الحرب ما بين القدس، من جهة، والعالم كله، من جهة أخرى، نحن نفترض أن الطلاب الجامعيين المناصرين للفلسطينيين هم، في أغلبيتهم الساحقة، أغبياء وسُذّج، بل معادون للسامية ربما. نحن لا نستوعب أن كثيرين جدًا من هؤلاء يفهمون كذبتنا القومية الكبيرة ويفهمون، أيضًا، أننا نهاجم ونقصف ليس من أجل أن نبقى موجودين كدولة يهودية، بل من أجل أن نواصل الاحتلال.. بكلمات أخرى، نحن لا نرى العمى الذي أصابنا ونعاني منه نحن، بل نستنتج فقط أن شيئًا ما ليس على ما يرام لدى هؤلاء الطلاب. إنها ردة الفعل الكلاسيكية المتمثلة في إطلاق النار على الرسول. في هذه الحالة، لأنه تخيّل شيئًا لا وجود له في الواقع، على الإطلاق ـ إنه يهذي وجود احتلال.. التبرير الأكبر الذي نقدمه نحن لهذا الأمر هو ما نسمّيه “الصراع”. ذلك أنه إنْ لم يكن هنالك احتلال، بل “صراع” فقط، فمعنى ذلك أن بإمكاننا عزو نتائج الاحتلال، التي تبدو مسيئة وظالمة ربما في أعين بعض الأغراب، إلى هذا “الصراع” الذي نشعر في إطاره بأننا مُهدَّدون بشكل دائم ودون توقف من جانب فلسطينيين معتدين وعليه، فنحن مُجبَرون بالتالي على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة، ليس للمحافظة على الاحتلال، بل على (القانون والنظام) في (المناطق)، لكن من أين ظهر لنا هذا الصراع؟ كيف عثرنا على (صراع) في الوضع الذي خرجنا فيه، في العام 1967، إلى حرب ضد الجيش الأردني في الضفة الغربية، فانتصرنا في تلك الحرب وفُزنا، في نهايتها، بأراضي أشخاص لم يُحاربوا ضدنا في تلك الحرب؟ أي نوع من الصراع لدينا مع هؤلاء الناس؟ ما الذي فعلوه ليبرر حقيقة أننا، بعد مضي 55 سنة على الحرب التي وقفوا خلالها متفرجين، لا نزال نستولي على ـ أي، نحتل ـ أراضيهم بالقوة إلى درجة أنه ينبغي عليهم الآن، لأنهم “تصارعوا معنا”، الموافقة على التفاوض معنا ومنحنا جزءًا، على الأقل، من أراضيهم قبل أن نقبل بالعودة إلى بيوتنا.”!؟
وخلص إلى أنه “نظرًا لأننا لا نطرح مثل هذه الأسئلة، عادة، نشعر بالارتباك حين يرفض الفلسطينيون منحنا أي جزء من أراضيهم، في شرقي القدس على سبيل المثال. وعندئذ، نضع هذه الحقيقة في إطار ثروتنا اللغوية ونواصل، حسب مفهومنا، (إدارة الصراع) ـ وليس الاحتلال، غير القائم أصلًا.. من جهتنا، في السطر الأخير، نحن نخوض حربًا هي، في واقع الأمر، ليست (حربًا) وإنما (أعمال بوليسية)، كتلك التي استخدمها البريطانيون لقمع التمردات إبّان فترة الانتداب البريطاني؛ وهو ما يفسر، إلى حدّ ما على الأقل، أسباب رفض حكومتنا، حتى الآن، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولو مقابل إعادة المخطوفين، كلّهم أو بعضهم. فالحروب تنتهي، أحيانًا، بوقف إطلاق النار. كما حدث، مثلًا، في حرب التحرير التي انتهت بتلك الصورة في العام 1949. أما في حالتنا الحالية هذه، فإنّ الحكومة تقول إن هذه (الحرب) لن تتوقف إلا بعد تحقيق (الانتصار المطلق). حتى عندما يقترح بايدن علينا خارطة الدولتين التي يمكننا بواسطتها الخروج من هذا (الصراع)، يتعمد نتنياهو، غالانت، ليبرمان، ساعر، غانتس وبن غفير وسموتريتش بالتأكيد، الحديث عن استمرار القتال البري والغارات الجوية على أن تفقد حماس قدرتها على مضايقتنا. أو، بكلمات أخرى، حتى تكبر “قوة الردع” لدينا إلى درجة لا تبقى فيها لدى حماس أو أية مجموعة أخرى من (المعتدين الفلسطينيين) أية قدرة على تحدّي الاحتلال مرة أخرى. من وجهة نظر هؤلاء ـ ووجهة نظر إسرائيليين كثيرين يصدّقون هذه الكذبة ويرددونها ـ هذا هو ما سبّب أحداث السابع من تشرين الأول. ليس وجود الاحتلال، وإنما الفشل في إنتاج المزيد من الردع القادر على إبقاء حماس في مكانها. وهذا، كما يقول الكذابون الكبار، هو ما يمكننا إصلاحه الآن”؟!