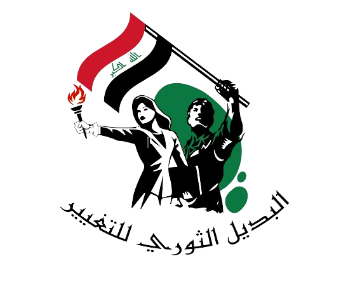الأزمة السورية بعد عشر سنوات
نشرت صحيفة زافترا مقالا للكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر جاء فيه:
دخلنا في العام الحادي عشر للأزمة السورية ما رأيك، متى بدأت فعليا؟ ومتى ستنتهي؟ متى نرى الدفع بكل اللجان الأخرى (معتقلين، لاجئين) لأنها ملفات ثقة مهمة، وأنت تعلم بأن الشعب السوري لم يعد يصدق بأن هذا الظلام سيرحل عنه يوما ما؟
إذا ما أردنا الحديث بصراحة، وإذا ما توخينا الواقعية والموضوعية، فإن الأزمة السورية لم تبدأ، كما هو معروف الآن في وسائل الإعلام المختلفة، عام 2011، بالتزامن مع ما سمي بـ “الربيع العربي”، وإنما تمتد جذورها لما هو أبعد من ذلك، وتحديداً إلى عام 1970، أو ما سمي بـ “الحركة التصحيحية”، التي أطاحت بالرئيس نور الدين الأتاسي، والتي كانت في واقع الأمر انقلاباً عسكرياً في الجمهورية العربية السورية، جاء بأحمد الحسن الخطيب رئيساً مؤقتاً للجمهورية، ثم وصل بعدها آل الأسد، حافظ ثم ابنه الدكتور بشّار، إلى سدة الحكم في البلاد، وأمسكا بمفاتيح السلطة حتى يومنا هذا. لقد مرت سوريا بثلاث أزمات حادة، أولها أحداث حماة، عام 1982، حينما حوصرت مدينة حماة عسكرياً لمدة 27 يوماً، بغرض قمع انتفاضة الإخوان المسلمين ضد الحكومة، وراح ضحية تلك الأحداث آلاف القتلى بين المواطنين وجنود الجيش العربي السوري، تختلف التقديرات في حصرهم ما بين ألفين حتى تصل إلى عشرين وحتى أربعين ألفاً في بعض التقديرات! كانت الأزمة الثانية فيما قيل إنه محاولة انقلابية لعزل حافظ الأسد من قبل أخيه رفعت الأسد، عام 1984، إثر دخول الأول في غيبوبة مرضية، ثم أرغم حافظ أخيه رفعت على مغادرة البلاد. وقتها قيل كذلك إن الأمور كانت قد تصاعدت إلى نزاع بين القوات التابعة لرفعت الأسد والقوات الحكومية، الذي هدد بإحراق العاصمة دمشق، قبل أن يتمكن حافظ الأسد من احتواء الأمر، وفقاً لرواية وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس. أما الأزمة الثالثة فكانت الغليان الذي ما لبث أن تحوّل، في نهاية المطاف، إلى انفجار حقيقي، متزامناً مع “الربيع العربي”، الذي أثبت الزمن أنه لم يكن “ربيعاً”، ولا “عربياً”. ومع تفهم الدوافع الموضوعية للاحتقان الشعبي في البلاد التي طالها ذاك الربيع، وطيلة السنوات التي سبقت اندلاع الأحداث في سوريا، وتحديداً عقب صعود الرئيس، بشار الأسد، خليفة لوالده، وبعد ما قام به الأسد من إصلاحات محدودة، لم تصل، أو لنقل، لم تساعدها الظروف الخارجية أو الداخلية في أن تصل للمواطن السوري البسيط، وأتحدث هنا، خارجياً، عن ارتفاع أسعار الغذاء، بسبب أزمات اقتصادية عالمية، في 2008 وما تلاها، ثم ارتفاع أسعار القمح في 2010، بعد موجة الجفاف والحرائق، التي ضربت روسيا صيف ذلك العام، وارتفاع أسعار القمح بـ 30%، وأتحدث داخلياً عن الفساد والمحسوبية والتفاوت الطبقي وغلاء الأسعار، ناهيك عن الثأر الذي ظل يغلي، لثلاثة عقود، في صدور أبناء وأهالي الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معهم من التيارات المختلفة، والتي كانت تحظى بدعم دول عربية إقليمية، وقوى أخرى دولية. أقول إن ذلك الانفجار، بكل ظروفه وتداعياته، دفع، في لحظة خائنة، سوريا إلى الانزلاق نحو منعطف شديد الخطورة، كاد أن ينهي وجود الدولة السورية الموحدة بالأساس، مرة واحدة وللأبد. حينها تدفقت الأموال والأسلحة بجنون من كل حدب وصوب على تنظيمات وألوية وكتائب لا حصر ولا عد لها، وانتقلنا، بتسارع ملفت، من الجيش السوري الحر، المنشق عن الجيش العربي السوري، إلى جبهة النصرة، وفتح الشام، ثم هيئة تحرير الشام، ليظهر بعد ذلك عدد مهول من التنظيمات التي يصنف بعضها إرهابياً على قوائم الإرهاب الدولي، مثل فيلق الشام ولواء شهداء الإسلام وجيش إدلب الحر ولواء صقور الجبل وجيش النصر وألوية صقور الشام إلخ. كما دخلت سوريا عناصر إرهابية أجنبية من جميع أنحاء العالم، بل وأصبحت الرقة عاصمة سورية لما سمي بـ “الدولة الإسلامية”، التي كانت في بداية الأمر “دولة إسلامية في العراق والشام” (داعش)، ثم أصبحت “الـ” دولة “الـ” إسلامية بالألف واللام، تعبيراً عن شموليتها واحتضانها لـ “المسلمين” من جميع أنحاء العالم، وتطلعها لاستدامة وجودها، وربما كانت بالفعل لتستمر في الوجود، بدعم إقليمي ودولي، لولا ما حدث من ثورة 30 يونيو في مصر، عام 2013، وإنهاء حكم الإخوان المسلمين هناك، ثم دخول روسيا على الخط، عام 2015، بعدما طلبت الحكومة السورية الشرعية مساعدتها رسمياً، وفقاً للأعراف والقوانين الدولية، ليتحول الوضع 180 درجة في الاتجاه المعاكس، وليتم إنقاذ الدولة السورية، بعدما كانت على شفا الانهيار الكامل، وبعدما وقعت العاصمة دمشق تحت الحصار، في انتظار مذبحة كانت لتزهق أرواح مئات الآلاف من المواطنين السوريين، خلال أيام معدودات.
لقد بدأت “الثورة” السورية، بمسيرات سلمية، ومطالب شرعية، لا يختلف حولها أحد، إلا أن طبيعة الحشود، والحشود المضادة، وما أطلق عليه وقتها “الشبيحة”، وربما “الطرف الثالث”، و”الرابع” و”الخامس”، وبعد أن تحول الوضع إلى أن أحداً لم يعد يعرف من يطلق النار على من، دفع ذلك حينها بمطالبات خبيثة بـ “تسليح الثورة”، لتتدفق أموال الخليج، وتنسيق دول إقليمية مجاورة، ومنظمات دولية، لتصبح سوريا، ولا تزال حتى اليوم، ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية، ابتعدت بـ”الثورة السورية” عن مطالبها الأساسية بالعدل والمساواة وتداول السلطة، لتحتضنها أنظمة ودول وتكتلات، ولتتفرق منصّات المعارضة بين الدول من أصحاب المصالح، الأمر الذي أعطى القيادة في دمشق ورقة لعب رابحة، أصبحت تتلاعب بها قدر استطاعتها، فالمنصات تتغير، والوجوه تتبدل، و”النظام” واحد، وممثلوه لا يتغيّرون ولا يتبدلون. من هنا كانت حجة القيادة في دمشق، في “عجزها عن الاتفاق” بسبب “اختلاف وخلاف المعارضة”، وهو ما أضاع وقتاً طويلاً، حتى اتفقت الحكومة والمعارضة على “أطراف محددة” وتشكيل معين للجنة دستورية، برعاية وضمانة ودعم من هيئة الأمم المتحدة وبضمانة دول مسار أستانا، روسيا وإيران وتركيا، في ظل وقف لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ومناطق للتهدئة، بهدف إلى رفع المعاناة قدر الإمكان عن الشعب السوري، الذي يعاني أزمة إنسانية تتفاقم بسرعة متزايدة، خاصة مع ظهور جائحة فيروس كورونا، وغياب أي خدمات صحية، ناهيك عن شح الطعام والتدفئة والمرافق.
لذلك، يبدو الحديث عن أي ملفات أخرى سوى ملف التسوية السياسية، وملف الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، هو حديث يفاقم الأزمة ولا يعالجها، وحديث يسرّ السلطة في دمشق أن يدور في أروقة المعارضة، لما يحمله من سم في العسل. فبالطبع تستمد المعارضة شرعيتها ووظيفيتها من طرح تلك القضايا الساخنة والعالقة مع “النظام”، وتريد المعارضة أن “تكسب أرضاً سياسية” بطرح تلك القضايا، حتى تعود لأرضيتها الشعبية بـ “إنجازات” على الأرض. إلا أن الوضع السوري أعقد وأصعب من ذلك بكثير، لأننا حينما نتحدث عن الأولويات في الأزمة السورية، يجب أن نتذكر أن شعباً بأكمله يقع تحت الحصار الاقتصادي المجحف بحقه، في انتظار دستور جديد، وانتخابات، وحل للأزمة. ومهما كانت علاقتنا بـ “النظام” أو القيادة في دمشق، سمّها ما شئت، إلا أنها، وعلى الرغم من كل شيء، هي الحكومة الشرعية “المنتخبة” بطول البلاد وعرضها، والممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، لذلك فإن رفع الحصار يظل الأولوية المطلقة حتى تصل المساعدات إلى الشعب الجائع والمريض والفقير في آن، ورفع الحصار وإعادة الإعمار يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو ما لن تستطيع تجاوزه أي جاليات سورية في الخارج، مهما كانت سطوتها وتأثيرها على الدول التي توجد بها، وليس بوسع تلك الجاليات سوى التضامن والمواساة، وربما إرسال بعض المساعدات المالية المحدودة للأقارب لا أكثر. أما الحديث عن أي أنشطة أخرى، فسوف تكون مرفوضة بحكم العقوبات المفروضة على “نظام الأسد”. هل نرى اليوم توافقاً روسياً أمريكياً على الحل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وهل هنالك بدائل أخرى (الرؤيا الخليجية)؟ وهل كان الأمريكيون بالفعل مؤيدين لـ 2254، كما كان يسوق لنا؟ هل فعلا هنالك رؤى مختلفة لـ 2254 عن الرؤية الغربية؟ وهل فعلا المعرقل هم الإيرانيين وما هو دور إسرائيل؟ أم النظام؟
إن ذلك التوافق بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 موجود بالفعل، إلا أن الخلاف على آلية تنفيذ هذا القرار، حيث لا تعترف واشنطن بشرعية “النظام” الحالي في دمشق، وتسعى جاهدة لـ “محوه” من الوجود باستخدام الضغوط الاقتصادية، وهي تعلم تمام العلم، ويعلم معها بعض الدول الغربية والخليجية، أن تلك الوسيلة للضغط لا يمكن أن تستمر للأبد، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعتبر الرضوخ للأمر الواقع، والتعامل مع “نظام الأسد” بهيئته الحالية، بمثابة هزيمة لها، وللمسار الذي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الأزمة، لهذا تستمر في الضغط بهذا الاتجاه، حتى ولو كان على حساب أرواح البشر، ومعاناتهم الإنسانية. على الجانب الآخر، تعترض روسيا على ذلك، وتصرّ على أن قرار مجلس الأمن واضح في مفرداته بإطلاق حوار بين المعارضة والنظام، الذي تمثله الحكومة الشرعية في البلاد بقيادة الرئيس السوري، بشار الأسد، وهنا يكمن الاختلاف في الرؤى بين الطرفين الروسي والأمريكي.
كذلك فقد قامت روسيا بعقد “مؤتمر الحوار الوطني السوري”، أو مؤتمر سوتشي، عام 2018، بمدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، وكذلك شاركت وساهمت بدور فعال في مؤتمرين دوليين، عام 2020 و2021، حول عودة اللاجئين السوريين، إلا أن الوضع الداخلي في سوريا، بما في ذلك الجمود الذي يكتنف العملية السياسية، ومحاولات عرقلتها، يزيد من رغبة الهجرة من سوريا، وليس العودة إليها. وليس سراً أن عائلات تبيع كل ما تملكه من أجل أن يهاجر أبنائها من سوريا، في ظل رواج لعصابات تسهيل الهجرة التي أصبحت تعرض الهجرة إلى تركيا وأوروبا بأسعار خيالية. (4 آلاف دولار لتركيا، و12 ألف دولار لأوروبا!)
إن روسيا تصرّ على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا لابد وأن تتم عبر توافق سوري سوري، يقره السوريون وحدهم، ولا ترى بديلاً عن ذلك، وتحذّر دائماً من حرب أهلية طائفية جديدة لا يعلم مداها وعواقبها سوى الله وحده. لهذا، تؤكد روسيا على ضرورة المضي قدماً في مسار جنيف، ودعم عمل اللجنة الدستورية المصغرة، والتوصل إلى تعديل دستوري يضمن حقوق السوريين جميعاً، ولا يقصي أحداً، ولا يترك مجالاً لأي توجهات انفصالية، ويحفظ وحدة سوريا، واستقلال أراضيها، وحرية وكرامة شعبها.
إلا أنه، وحتى الآن مع الأسف الشديد، لا تحظى اللقاءات بأجواء بنّاءة، حيث لا زالت واشنطن تسعى لإعاقة عمل اللجنة الدستورية، وتجد لمساعيها صدى داخل وفدي النظام والمعارضة، فالنظام بذلك يحافظ على بقاء الأمور على ما هي عليه، ولا يرى بالتالي أي داعٍ لتغيير الدستور، والمعارضة تظن أنها بذلك إنما تعلّي من سقف مطالبها، فيتطرق وفد الحكومة، خلال الاجتماعات، التي تناقش قضايا الدستور وتفاصيله القانونية الدقيقة، لمفاهيم نظرية عامة حول مفهوم “سيادة الدولة” ومعنى “السيادة”، بينما تتطرق المعارضة لقضايا المعارضين، والمختفين قسرياً، والمعتقلين وخلافه من القضايا التي لا محل لها من الإعراب في لجنة صياغة الدستور. هم مواطنون سوريون إذن هم من يقوم بإفشال التقدم في مسار الحوار السوري السوري، وليست إيران أو إسرائيل أو أي من القوى الخارجية. مواطنون سوريون مكبّلون بأجندات سياسية وإقليمية وربما شخصية، تمنعهم من مساعدة بني أوطانهم، ممن ينامون في العراء، ويموتون من البرد والجوع والمرض والفقر. لنتحدث ببساط أحمدي، ماهي مصالح روسيا في سوريا، الجيواستراتيجبة والاقتصادية؟ وهل ستساعد روسيا اقتصاديا سوريا المستقبل على عودة الأحياء، ودفع دول العالم للمساهمة بذلك؟ وهل هذا يحتم على روسيا الدفع بإنشاء نظام قضائي شفاف ونزيه لتقديم الضمانات للدول ومكافحة الفساد؟
سأكون صريحاً. لابد وأن نتحدث عن سوريا، من منظور الأمن القومي الروسي. لقد كان هدف العملية الروسية في سوريا هو مساعدة الدولة الصديقة لروسيا، وحماية أمنها، والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، إلا أن من بين المهام الاستراتيجية، التي تدركها القيادة السياسية في موسكو، هو الدفاع عن الأمن القومي الروسي من خلال مكافحة الإرهاب الذي هدد من قبل، ولا زال يهدد، بين الحين والآخر، منطقة القوقاز، بطن روسيا الرخو، الذي تسرّبت من خلاله في السابق أموال وأسلحة وعناصر إرهابية، حينما اندلعت حرب الشيشان، تسعينيات القرن الماضي، الحرب والعمليات الإرهابية التي لا زالت ماثلة في ذاكرة الشعب الروسي. من هنا، وبعد تقارير استخباراتية من أطراف متعددة، بشأن انتقال عدد من العناصر الإرهابية من القوقاز إلى سوريا والعراق، كانت حرب هذا العدو خارج الحدود الروسية أمراً مهماً ومجدياً لروسيا، دفاعاً عن أمنها القومي. كذلك فإن قضية مكافحة الإرهاب هي قضية ذات أبعاد دولية، تخص العالم أجمع، ولا تخص روسيا أو سوريا وحدهما. وكما دافع الاتحاد السوفيتي في يوم من الأيام عن أمن وحرية واستقلال أوروبا والعالم، بانتصاره على النازية، فإن روسيا اليوم قد اضطلعت ولا تزال تضطلع بمهمة التخلص من البؤر والعناصر والتنظيمات الإرهابية الموضوعة على قوائم الإرهاب الدولي، وتحييدها والتخلص منها قبل أن تتمكن من التأثير على الأمن القومي الروسي متمثلاً في القوقاز، وقبل أن يمتد تأثيرها لأماكن أخرى في العالم.
هل ترى روسيا ترابطاً بين الملف السوري والملفات الدولية الأخرى، والملفات الإقليمية؟
يحاول البعض كذلك، فيما سمعت مؤخراً، الربط بين الملف السوري، وملفات دولية أخرى، لعل على رأسها المحادثات الدائرة الآن بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبين روسيا وحلف “الناتو”، وينسجون قصصاً وحكايات حول “مقايضات” روسية، و”تنازلات” و”موائمات” بشأن الأزمة السورية. بهذا الصدد أود التأكيد على أن الملف السوري هو ملف إنساني بامتياز، والأزمة السورية منفصلة عن أي من الأزمات الدولية الأخرى، وهي إحدى أكبر الأزمات الإنسانية التي تشهدها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، ومهما كانت البدايات، والنوايا الحسنة التي عبّدت طريقاً إلى الجحيم، إلا أنه يجب الآن التعامل مع تلك الأزمة من منظور الحرب على الإرهاب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والدول والقارات، ويجب توحيد كل الجهود من أجل المساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري، والتفرقة ما بين المواطنين المدنيين العزل، والتنظيمات الإرهابية التي تتخذ منهم دروعاً بشرية، فالضحية في نهاية المطاف هي عامة الشعب السوري. ولم يعد لدينا الآن رفاهية “إنهاء” العامل الدولي، إلا أن “دولية” الأزمة السورية لا تتقاطع من قريب أو من بعيد مع “دولية” الأزمة الأوكرانية، أو “دولية” أزمة كازاخستان مؤخراً، أو أزمة ترانسيستريا وغيرها من الأزمات المحيطة بروسيا، والتي يساهم “الناتو”، بمناوراته وأسلحته وتحركاته العسكرية، في إبقائها متوترة. عبر التاريخ كانت روسيا بعلاقة متميزة مع الحكومات السورية وداعمة لها في قضاياها العادلة وحروبها؟ أما اليوم هل فعلا لا ترى روسيا في مستقبل سوريا سوى الأسد؟ مع العلم أننا نعلم أن أهم أسباب الأزمة هي هذه العائلة في سوء الإدارة، بالإضافة للفساد الكبير الذي ضرب كل أركان الدولة عبر عشرات السنين، واليوم سوريا في مقدمة الدول في الفساد في العالم؟ كيف يمكن أن يتماهى النظام الروسي الذي قطع أشواط كبيرة في الديمقراطية (فارق كبير بين الاتحاد السوفيتي وروسيا اليوم)، وتقوية القضاء بعد تضحيات كبيرة دفع ثمنها الشعب الروسي، فكيف لروسيا أن تدعم نظام شمولي يختلف عنها كليا وعن تفكير وتطلعات شعبها؟
يؤكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دائماً على أن العلاقات المتميّزة بين الدول إنما تستند بشكل أساسي إلى مصالح شعوبها، بمعنى أنه حينما يتحدث، فإنما يتحدث نيابة عن الشعب الروسي، مدافعاً عن مصالحه العليا. لذلك كانت العلاقة المتميزة بين روسيا وسوريا هي علاقة وطيدة وعميقة وممتدة بين الشعبين الروسي والسوري، الذين تربطهما أواصر صداقة ومحبة وتعاون وتعليم وثقافة تعود لعقود مضت، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي. وقد خطت روسيا خطوات واسعة خلال عقدين من الزمان نحو حوكمة وديمقراطية المؤسسات التي لا تعتمد على الأشخاص قدر اعتمادها على الآليات واحترافية العمل والإدارة، وهو ما ترغب أن تتبادله، وتراه واقعاً في سوريا، دون أي تدخلات أو إملاء.
وأعيد ما أسلفت من قبل، أن سوريا للسوريين، وحل الأزمة السورية بيد السوريين وحدهم، وكل ما تسعى إليه روسيا بهذا الشأن هو توفير الأجواء الإيجابية والبنّاءة والمنصات والدعم المطلوب لدفع هذه العملية قدماً، وسوف تتعامل الدولة الروسية مع الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب السوري دائماً وأبداً، وفقاً لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وستسعى دائماً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للوصول بسوريا إلى بر الأمان. أما فيما يتعلّق بمنظومة الفساد، وما يطرح من إحصائيات وتصنيفات، فإن روسيا دائماً مستعدة لنقل خبرتها في مكافحة الفساد، وأتمتة الإدارة، وتقليص تدخل العنصر البشري في اتخاذ القرارات، وآلية عقد اللجان وغيرها من آليات مكافحة الفساد التي اتبعتها، ولا تزال تتبعها لمكافحة الفساد.
هل ستعمل روسيا مع الدول العربية الكبرى كالسعودية ومصر للدفع بـ 2254، وتدعم فكرة إخراج كل الجيوش الغربية عن الأرض السورية بما فيها الجيش الروسي؟ وهل على الجاليات السورية التعاون مع روسيا في ذلك؟
إن روسيا دائماً ما تطرح الملف السوري في جميع المحادثات التي تقوم بها على مستوى وزارة الخارجية الروسية مع الشركاء في المنطقة، خاصة مع المملكة العربية السعودية ومصر، حيث تتبنى روسيا موقفاً واضحاً ومحدداً، وهو ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسلمية انتقال السلطة، واستقرار الأوضاع، وبالتالي إخراج كل القوات الأجنبية بموافقة الحكومة السورية المنتخبة الجديدة.
هل يمكن للشعب السوري أن يحقق مطامحه بالعدالة والديمقراطية والحرية والتعددية، ككل شعوب العالم؟ وهل روسيا ملتزمة على المساعدة بذلك، وتستطيع فرض ذلك؟ وتقديم نموذج حضاري لكل الوطن العربي والعالم؟
لقد آن الأوان للشعب السوري الأبيّ، الذي عانى ويلات الحروب، وقسوة الجوع والبرد والتشرد، أن يعيش بحرية وكرامة وعزة، بعد أن سطر بدمائه طريق الحرية، وعبّد بأجساد أبنائه مسار الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة. حان الوقت كي يعيش ذلك الشعب المكلوم والمثخن بالجراح، بحرية وعزة وكرامة، شأنه في ذلك شأن بقية شعوب العالم، وروسيا تضع نصب عينيها ذلك الهدف، دون اللجوء للقوة إلا في حالات الضرورة القصوى لمكافحة الإرهاب والعنف، وتأمل روسيا أن تتمكن القوى الوطنية الحقيقية المحبّة للسلام، والمقدّرة لتضحيات الشعب السوري، من الالتفاف حول كلمة سواء، يجتمع حولها الخصوم، بعدما شردت الحرب الأهلية السورية ملايين السوريين، وقتلت مئات الآلاف من أبناء الوطن السوري الواحد، ممن راحوا دفاعاً عمّا يظنونه جميعاً “الحق المبين”، على جبهات القتال المختلفة.
رأينا الدور الإيجابي لروسيا في منع اقتحام درعا البلد من ميليشيات النظام السوري والعودة للتهدئة، وكان لكم دور كبير في ذلك، هل سنرى ذلك في إدلب وشرق الفرات، وهل بإمكاننا القول بأن الحرب قد انتهت على الأرض السورية؟ وهل يمكن الوثوق بروسيا في المستقبل؟
كما أسلفت، وكما كان لروسيا دور إيجابي في منع اقتحام القوات الحكومية لدرعا البلد، والعودة للتهدئة، فروسيا أيضاً، كدولة ضامنة من دول مسار أستانا (روسيا وإيران وتركيا) ملتزمة بالتهدئة، وبوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ونأمل أن تلتزم الأطراف الأخرى في إدلب وشرق الفرات بضبط النفس، والابتعاد عن الإجراءات الاستفزازية، التي من شأنها أن تشعل فتيل الاضطرابات والمواجهات في أي لحظة، في وقت يقع فيه الجميع تحت ظروف ضغط هائل من جميع الجهات. ويضطلع المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا بمهمة تسهيل عقد الاتفاقات بين الحكومة وجماعات المعارضة، علاوة على المهام الإنسانية، وعلى رأسها إيصال المعونات الإنسانية لمستحقيها، وأعتقد أن ما فعلته روسيا حتى اللحظة على مدار ما يربو على ست سنوات كفيل بزرع الطمأنينة في نفوس الشعب السوري الصديق، الذي يدرك تماماً، بعد تجربة الحرب العصيبة، الفرق بين العدو والصديق. لذلك، فكلي ثقة أن تظل روسيا تشغل موقع الشريك الموثوق، كما كانت في الماضي والحاضر.وما المطلوب من الجاليات السورية فعله في مجال مساعدة بلادهم، وهل يمكن تشكيل لجان تقنية بين الجاليات السورية حول العالم، والمؤسسات الروسية في المجال الإغاثي وإعادة الإعمار؟
فيما يتعلّق بالجالية السورية في روسيا، فإنها جالية مشتّتة، وحتى مع سعي بعض الأشخاص المعدودين على الأصابع لتقديم مساعدات لشعبهم، إلا أن إمكانيات هؤلاء هي الأخرى محدودة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة الروسية هي من تضطلع بهذا الدور، وتقدم المساعدات لسوريا، بموجب اتفاقيات اقتصادية لتزويد سوريا بالقمح والوقود وتشغيل محطات توليد الطاقة، وتوفير المعونات الإنسانية والمعدات والأجهزة والأطقم الطبية قدر الإمكانيات المتاحة لدى روسيا. لهذا، فمن السابق لأوانه الحديث عن إعادة الإعمار، قبل البدء بعملية الانتقال السلمي في سوريا، وتوفير أجواء المصالحة الوطنية، التي تسمح لعامة الشعب بالمساهمة في بناء واقع جديد لبلادهم.
أما فيما يخص إعادة الإعمار، والعقود طويلة الأمد في روسيا، فذلك أمر يعود في نهاية المطاف للشعب السوري، وله وحده. لهذا نتطلع في روسيا لأن تمضي اجتماعات جنيف على نحو مثمر وبنّاء، لكتابة دستور جديد للبلاد، تعقد على أساسه انتخابات شفافة ونزيهة، يشارك فيها جميع السوريين، لاختيار قيادتهم. بعدها يكون لكل مقام مقال.