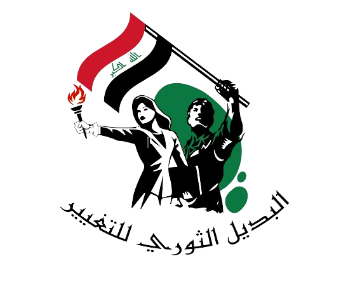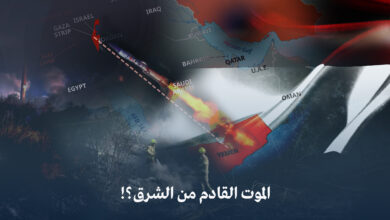سيتحول الأقصى من الآن فصاعداً إلى صاعق تفجير لكل جولات الصراع المقبلة مع “إسرائيل” إلى أن ينهار المشروع الصهيوني من أساسه.
لسنوات طويلة أعقبت إعلان قيام دولة “إسرائيل” عام 1948، بدت هذه الدولة الدخيلة على المنطقة حريصة على إظهار نفسها بمظهر الدولة المسالمة والمحاصَرة بطوق من العداء العربي. صحيح أن الطابع العسكري والتوسّعي لهذه الدولة، التي قامت على أنقاض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، راح يتأكد تدريجياً، سواء من خلال غارات متكررة لم تكفّ “إسرائيل” عن شنّها على الدول العربية المجاورة، أم من خلال مشاركتها مع فرنسا وبريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، إلا أنها نجحت في تسويق نفسها في الوقت ذاته، كدولة ديمقراطية علمانية، وسط بحر من الاستبداد والتطرف العربيّين. ساعدت على ذلك سيطرة حزب العمل على الحياة السياسية الإسرائيلية من دون انقطاع، طوال الفترة الممتدة منذ التأسيس حتى حرب 1967.
حين استيقظ العالم على هذه الدولة “الصغيرة المسالمة” وقد تمكّنت فجأة من إلحاق هزيمة مدوّية بجيوش ثلاث دول عربية، ومن احتلال مساحات شاسعة من أراضيها، شملت سيناء المصرية والجولان السورية والضفة الغربية الفلسطينية، بدأ العالم ينتبه أكثر إلى حقائق الصراع الدائر في المنطقة وإلى موازين القوى التي تحكمه أو تتحكم فيه. ورغم استمرار نظرة الإعجاب بتلك “الدويلة الصغيرة المحاصرة التي استطاعت كسر طوق الحصار المضروب حولها” على ما عداها، راحت القوى الرئيسية في العالم تركز انتباهها منذ ذلك الحين على ما قد تتيحه موازين القوى الجديدة على الأرض من فرص لتحقيق سلام قابل للدوام في المنطقة، من خلال صيغة تقوم على مبادلة الأرض المحتلة في حرب الـ 67 بسلام حقيقي بين الدول العربية و”إسرائيل”، وهي الصيغة التي تمتد جذورها في الواقع إلى قرار مجلس الأمن الرقم 242.
غير أن القدرة على تحويل هذا القرار، بما ينطوي عليه من معادلة ضمنية سمّيت في ما بعد صيغة “الأرض مقابل السلام”، إلى عملية سياسية يمكن للأطراف المعنيين أن ينخرطوا فيها بالفعل، لم تترجَم إلا بعد حرب 1973 التي اعتبرها بعض النظم العربية الحاكمة كافية “لغسل عار الهزيمة” والدخول من موقع الندية في مفاوضات سياسية مباشرة أو غير مباشرة مع “إسرائيل”. وهذا هو السياق الذي جرت فيه المفاوضات المباشرة بين “إسرائيل” وكل من مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن، والتي انتهت بالتوقيع على معاهدات سلام منفصلة أعوام 1979، 1993 و1994، على التوالي، وهو السياق نفسه الذي جرت فيه المفاوضات غير المباشرة بين سوريا و”إسرائيل”، عبر الوسيط الأميركي، والتي باءت بالفشل وتوقفت فعلياً عام 1999.
كان لافتاً للنظر أن النظم الحاكمة في العالم العربي بدت جميعها مقتنعة آنذاك، رغم مظاهر التعنّت الإسرائيلي الواضحة طوال مراحل التفاوض المختلفة مع كل الأطراف العرب، بإمكانية التوصل إلى تسوية تفضي إلى انسحاب “إسرائيل” من الأراضي العربية التي احتلتها في عام 67، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في الضفة الغربية والقطاع، مقابل اعترافها بـ”إسرائيل” وتطبيع العلاقات معها في المجالات كافة، بدليل تبنّي مؤتمر قمة بيروت العربية المنعقد عام 2002، بالإجماع، مبادرة السلام السعودية التي استندت إلى الصيغة السحرية نفسها “الأرض مقابل السلام”، ومع ذلك، فقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه النظم جميعاً تجري وراء سراب. فـ”إسرائيل” لم تكن في الواقع مستعدة في أي يوم من الأيام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بل وبدت مقتنعة طوال فترة التفاوض مع الأنظمة العربية بأن هذه الأنظمة لن تستطيع التمسك طويلاً بأي مبادرة جماعية، ومن ثم، ستُضطر، إن آجلاً أو عاجلاً، إلى الدخول معها، أي مع “إسرائيل”، في تسويات منفردة تنتهي بتخلّيها كلياً عن القضية الفلسطينية. وهذا هو ما حدث بالفعل، بدليل إقدام عدد كبير من الدول العربية مؤخراً على تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”، في إطار ما عُرف بـ”صفقة أبراهام” التي أنهت عملياً صيغة “الأرض مقابل السلام”. وهكذا بدت أغلبية الأنظمة الحاكمة في العالم العربي كأنها تتجه فعلياً نحو الاستسلام الكامل للشروط الإسرائيلية والتخلّي التام عن القضية الفلسطينية.
بوسع أي متابع لِما أُطلق عليه اسم “العملية السياسية” التي استهدفت إيجاد تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، والتي انطلقت في أعقاب حرب عام 73 مباشرة ولا تزال مستمرة شكلاً حتى الآن، أن يتوصل إلى نتيجتين مترابطتين:
الأولى: أن هذه العملية وصلت إلى طريق مسدود تماماً، وخاصة بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد الثاني الذي رعاه بيل كلينتون عام 2000، وشارك فيه إيهود باراك، رئيس وزراء “إسرائيل” في ذلك الوقت، وياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت. فقد بدا واضحاً تماماً من خلال ما جرى في هذا المؤتمر استحالة ردم الهوة القائمة بين الرؤيتين الإسرائيلية والفلسطينية لتسوية القضية الفلسطينية. ويلاحَظ أنه لم تجرِ منذ ذلك الحين أي محاولة جادة أو مثمرة لتسوية القضية الفلسطينية، فضلاً عن أن المحاولات الشكلية التي بُذلت لاحقاً أثبتت أن الموقف الإسرائيلي يزداد تطرّفاً بمرور الوقت. فما عرضه باراك في مؤتمر عام 2000 كان في واقع الأمر أقصى ما يمكن لرئيس وزراء إسرائيلي أن يذهب إليه.
الثانية: أن قضية القدس، بصفة عامة، وقضية المسجد الأقصى، بصفة خاصة، هما الصخرة الحقيقية التي تتكسّر عليها كل محاولات التسوية. فبينما تمسّك عرفات بالسيادة الفلسطينية التامة على القدس الشرقية، وخاصة على القدس القديمة التي تضم المسجد الأقصى، لم يكن لدى رابين ما يقدمه لحل معضلة الأقصى سوى ذلك الاقتراح العجيب الغريب المريب، والذي حاول الفصل بين “السيادة فوق الأرض” والسيادة تحت الأرض”!
“إسرائيل” التي تفاوضت من قبل مع الدول العربية، ليست هي نفسها التي تفاوضت لاحقاً مع الفلسطينيين. فالتفاوض الإسرائيلي مع الدول العربية كان يجري حول الأرض والحدود بين دول تعتبر نفسها ذات سيادة، أما التفاوض الإسرائيلي مع الفلسطينيين فيدور حول الأرض نفسها والرموز نفسها، وبالتالي حول الوجود ذاته. فالقدس والأقصى، سواء بالنسبة إلى الإسرائيليين أم بالنسبة إلى الفلسطينيين، ليسا قضية أرض وحدود، يمكن التغلب عليها بالتنازلات المتبادلة والتعويض، بل هما قضية وجود ورموز، ومن ثم يستحيل حسمها إلا بالعودة إلى أصل الأشياء وجوهرها، أي إلى طبيعة المشروع الصهيوني وحقيقة ما يعبّر عنه، من ناحية، وإلى طبيعة الحركة الوطنية الفلسطينية وحقيقة ما تعبّر عنه، من ناحية أخرى.
فـ”إسرائيل”، من دون القدس و”جبل الهيكل”، هي مجرد “حل سياسي للمسألة اليهودية”، أي تعويض لليهود عن الاضطهاد الذي مورس ضدهم عبر التاريخ، وخاصة في أوروبا. وحين تتحول “إسرائيل” إلى كونها مجرد “دولة لجوء لشعب مضطهد”، سيفقد المشروع الصهيوني كل ادّعاء بالمشروعية الأخلاقية أو القانونية، ومن ثم يبدأ بالانحسار والتآكل التدريجي. والسؤال الذي يمكن أن يُطرح حينئذ: لماذا ينبغي على الشعب الفلسطيني أن يدفع ثمن جريمة لم يرتكبها؟
أما حين يتمسّك المشروع الصهيوني بادّعائه القائل إن “إسرائيل” هي التجسيد العملي لـ”عودة شعب الله المختار إلى وطنه بعد طول شتات”، فمن الطبيعي أن يختلف الوضع تماماً. حينئذ تصبح “إسرائيل” بالضرورة مشروعاً ناقصاً لا يكتمل إلا بالسيطرة على كامل الأرض التوراتية وإقامة الهيكل الثالث. وهذا هو الهدف الحقيقي للمشروع الصهيوني، والذي تمكن “اليسار” الإسرائيلي من طمسه وإخفائه طوال فترة هيمنته على الحياة السياسية في “إسرائيل”، ولم يبدأ بالانكشاف إلا تدريجياً، ومع تقدم اليمين الإسرائيلي نحو مفاصل القيادة في الدولة العبرية.
وفلسطين، من دون القدس والمسجد الأقصى، تصبح بدورها، وخاصة وفقاً للطروحات الإسرائيلية الراهنة لكيفية تسوية القضية الفلسطينية، مجرد مجموعة من الكانتونات المنفصلة، أشبه بملاذات أو محميات مخصصة لاستضافة أو لاستيعاب ما تبقى من شعب فلسطين على أرض أجداده. ومن الطبيعي أن تفقد حركة التحرر الوطني الفلسطيني، في سياق كهذا، كل مبرّر لوجودها. أما حين تستعيد هذه الحركة وعيها وتعود إلى ذاتها، باعتبارها حركة نشأت في الأصل ضد الاحتلال والانتداب البريطاني ثم ضد الاحتلال الاستيطاني اليهودي، فمن الطبيعي أن يختلف الوضع تماماً، لأن هدفها الأساسي والوحيد في هذه الحالة سيصبح بالضرورة تحويل فلسطين التاريخية إلى دولة مستقلة يتمتع شعبها بالسيادة على أرضه. وفي سياق كهذا، يصبح التمسك بالسيادة الكاملة على القدس، وخاصة على المسجد الأقصى، تجسيداً حيّاً لجوهر النضال الفلسطيني، وبالتالي مسألة أبعد كثيراً من مجرد التمسّك برمز ديني.
لا يتّسع المقام هنا لسرد تفاصيل السجل الإجرامي لـ”إسرائيل” في مجال تهويد القدس، أو لسرد تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، بدءاً من محاولة إضرام النار فيه عام 1969، حتى المحاولات الراهنة لذبح قرابين عيد الفصح داخل حرمه الشريف. كما لا يتّسع المقام هنا لسرد تفاصيل السجل البطولي للشعب الفلسطيني في مجال الذود عن مقدساته، وخاصة عن المسجد الأقصى. لكن من الواضح أن المقابلة بين هذين السجلين تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن “إسرائيل” ستواصل إصرارها على تهويد القدس إلى أن تتمكن من هدم المسجد الأقصى وبناء “هيكل سليمان” المزعوم مكانه، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله للذود عن القدس وعن المسجد الأقصى أياً كانت التضحيات.
ولأن الشعب الفلسطيني كله، بمسيحييه ومسلميه، بات ينظر إلى المسجد الأقصى باعتباره تجسيداً حياً لمشروعية نضاله، وليس باعتباره مجرد رمز ديني يخصّ المسلمين وحدهم، فمن الطبيعي أن يتحوّل الأقصى إلى راية يلتف حولها الشعب الفلسطيني المقاوم، ومن ورائه كل الشعوب العربية. لذا يمكن القول إن الأقصى سيتحول من الآن فصاعداً إلى صاعق تفجير لكل جولات الصراع المقبلة مع “إسرائيل”، إلى أن ينهار المشروع الصهيوني من أساسه