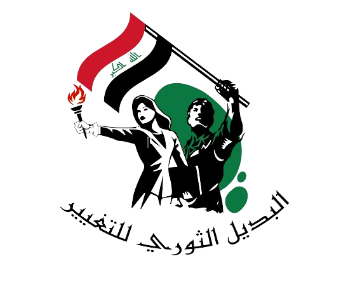جدل القوة والقانون في مرآة الأزمة الأوكرانية – بقلم الاستاذ حسن نافعة
يعتقد أنصار المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية أن القوة كانت ولا تزال هي المحرّك الرئيسي للتفاعلات الدولية.
هل تُدار العلاقات بين الدول استناداً إلى منطق القوة أم إلى قواعد القانون؟ سؤال مطروح على العقل البشري منذ قرون، وتحديداً منذ نشأة الدولة القومية في منتصف القرن السابع عشر، وما يزال يثير جدلاً لم يُحسم بعد.
يعتقد أنصار المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية أن القوة كانت ولا تزال هي المحرك الرئيسي للتفاعلات الدولية، ومن ثم يرون أن القيم وقواعد السلوك السائدة ما هي إلا انعكاس لموازين القوة القائمة في النظام الدولي. ويرى الفيلسوف الإيطالي الشهير ميكيافيللي (1469-1527)، المؤسس الحقيقي لهذه المدرسة، أن الوظيفة الأساسية للحاكم تنحصر في المحافظة على أمن بلاده والعمل على تحقيق مصالحها، ومن ثم، لدى كل حاكم الحق في استخدام الوسائل التي يراها ضرورية لتحقيق هذا الهدف، ولذلك عليه أن يتقن أساليب القوة والخديعة معاً، وأن لا يقيم أي وزن للقيم الأخلاقية أو لقواعد العدالة في تعاملاته مع الخصوم.
أما الفيلسوف البريطاني توماس هوبز (1588-1679) فقد نجح في التعبير بوضوح تام عن حالة الفوضى التي تتّسِم بها العلاقات بين الدول، حين ميّز بين “حالة المجتمع” و”حالة الطبيعة”. فهو يرى أن الأفراد داخل الدول، الذين يخضعون بالتالي لسلطة سياسية عليا تدير شؤونهم وفق عقد اجتماعي مبرم بين الحاكم والمحكوم، يعيشون “حالة المجتمع”، وهي حالة كفيلة بتحقيق السلم والأمن والطمأنينة للجميع. أما الدول، التي لا تخضع لسلطة فوقها، فلا تزال تعيش في ما بينها “حالة الطبيعة”، وهي حالة تتّسِم بالفوضى ويسودها قانون الغاب الذي يتيح للقوي أن يفتك بالضعيف.
ورغم عدم إنكار أنصار المدرسة الليبرالية في العلاقات الدولية للدور المؤثر الذي تلعبه القوة وموازينها في صياغة العلاقات الدولية، إلا أنهم يرون في الوقت نفسه أن القدرة على استخدام القوة في العلاقات الدولية لم تعد مطلقة كما كانت في الماضي، بل أصبحت مقيّدة بقواعد وحدود كثيرة يفرضها قانون دولي يتطور بمرور الوقت، تحت ضغط الحاجة إلى السلم والأمن في كل الأوقات. ويستشهدون على صحة هذه المقولة بوجود عدد كبير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، يزداد يوماً بعد يوم، كما يرون أن هذه المنظمات أصبحت تشكل في حدّ ذاتها أطراً مؤسّسية لإدارة العلاقات الدولية وتنظيمها، وذلك وفق قواعد قانونية عامة متفق عليها.
ولا شك في أن الأزمة الأوكرانية الراهنة، وبصرف النظرعمّا تنطوي عليه حجج هذه المدرسة أو تلك من مصداقية أو من قدرة على الإقناع، تعكس تحديداً حالة الجدل الذي ما زال محتدماً بشأن دور كلٍ من القوة والقانون في صياغة وتحديد شكل ومضمون ومسار التفاعلات الدولية. فبينما لجأت روسيا، أحد طرفي الأزمة، إلى القوة لحماية ما تعتقد أنه حق لها، وتعني بذلك حقها في المحافظة على أمنها القومي، تستند أوكرانيا، الطرف الآخر في الأزمة، ومن ورائها كل القوى الغربية، إلى القانون الدولي لتبرير حقها في انتهاج سياسة خارجية مستقلة، وبالتالي في طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
من المعروف أن إصرار الرئيس الأوكراني زيلنسكي على طلب انضمام بلاده إلى هذا الحلف كان السبب المباشر في اندلاع هذه الحرب الراهنة. وهو يستند في موقفه هذا إلى حق بلاده الكامل في ممارسة السيادة على كامل الأرض الأوكرانية، وفي رسم سياسة بلاده الخارجية بشكل مستقل، وبالتالي حقها في اختيار أصدقائها وحلفائها على الصعيد الدولي من دون تدخل أو إملاءات من جانب أي أطراف أجانب.
أما الرئيس بوتين فيرفض هذا المنطق تماماً، ويرى في انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو تهديداً لأمن بلاده، ومن ثم يستند في رفضه هذا إلى اعتبارات تتعلق بواجبه كرئيس لدولة روسيا في المحافظة على أمنها القومي، وخاصة أن السياسات التي ينتهجها حلف الناتو، والتي تقوم على نشر الأسلحة الاستراتيجية التابعة للحلف، بما فيها الأسلحة النووية على أراضي الدول الأعضاء فيه، ستؤدي حتماً إلى نشر أسلحة نووية معادية على حدود روسيا الغربية مباشرة، ما يمثّل تهديداً فعلياً لأمنها القومي، ويبرّر ضرورة التصدي لهذا التهديد ومواجهته، ولو باستخدام القوة المسلحة، وهو ما تمّ فعلاً.
إذا نظرنا إلى موقف الطرفين، الروسي والأوكراني، في مرآة الجدل المحتدم بين القوة والقانون في العلاقات الدولية، فسوف نجد أن موقف الرئيس الأوكراني يستند بوضوح إلى قواعد ثابتة ومتفق عليها في القانون الدولي، وبالتالي يتسِق تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة، بينما يستند موقف الرئيس الروسي إلى منطق القوة التي يُعَدّ استخدامها فعلاً، أو حتى مجرد التهديد باستخدامها، خروجاً عن القواعد المقررة في القانون الدولي، وبالتالي خرقاً واضحاً وصريحاً وفاضحاً لميثاق الأمم المتحدة.
غير أن هذه النظرة تبدو شكلية تماماً، ومن ثم غير قادرة على الغوص في أعماق العلاقات الدولية والعوامل المحركة لتفاعلاتها. فمن الواضح تماماً أن موقف الرئيس الأوكراني، والذي يُعَدّ امتداداً لسلطة وصلت إلى مواقع الحكم عبر “ثورة ملونة” مدعومة أميركياً، لم يكن في موقفه المطالب بالانضمام إلى حلف الناتو مدفوعاً بالحرص على استقلال القرار الأوكراني، بقدر ما كان متجاوباً مع التحريض الأميركي الداعي إلى محاصرة روسيا ومنعها من التحول إلى قوة دولية منافسة. لذا لا يمكن فهم الأزمة الراهنة في سياق متطلبات وتبعات علاقة ثنائية تربط بين روسيا ودولة جارة، كانت في ما مضى جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد السوفياتي، ولكن في سياق علاقة عدائية محتدمة مع الولايات المتحدة التي تستهدف محاصرة روسيا وخنقها، رغم انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال الإصرار على توسعة حلف الناتو وعلى امتداده شرقاً، رغم إقدام حلف وارسو على حل نفسه بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
على صعيد آخر، يُلاحَظ أنه ما كان يمكن تصور لجوء روسيا إلى خيار القوة العسكرية في الأزمة الأوكرانية، بكل ما ينطوي عليه من خروج عن القانون الدولي وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ما لم تكن الولايات المتحدة نفسها قد لجأت إلى هذا الخيار المحرّم نفسه مِراراً وتكراراً، ولأسباب مفتعلة تبدو واهية تماماً بالمقارنة مع الأسباب الروسية المعلنة.
لنأخذ ما قامت به الولايات المتحدة في العراق عام 2003، على سبيل المثال لا الحصر، ونقارنه بما قامت به روسيا في أوكرانيا منذ أيام قليلة. ففي عام 2003 أقدمت الولايات المتحدة على غزو واحتلال دولة تبعد عنها آلاف الأميال، وبالتالي لا يمكن تصور أن تمثّل أي تهديد مباشر لها، ثم قامت بإسقاط نظامها الحاكم وتنصيب نظام عميل مكانه، ما أدى إلى وقوع ملايين القتلى والجرحى في صفوف العراقيين، وإلى تدمير دولتهم التي لا تزال تعاني حتى الآن من الآثار الناجمة عن الغزو والاحتلال الأميركيّين. ولتبرير هذه الجرائم، ادّعت إدارة بوش الابن كذباً أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وقدّم وزير خارجيتها وثائق في مجلس الأمن لإثبات هذا الادعاء، تبيّن في ما بعد أنها مزوّرة. والأخطر من ذلك أنها ادّعت حينذاك وجود تفويض سابق من مجلس الأمن يبيح استخدام القوة ضد العراق، لكن مجلس الأمن رفض هذا التفسير كما رفض منحها تفويضاً جديداً باستخدام القوة، ومع ذلك لم ترتدع عن شنّ حرب عدوانية على العراق. ومن الصعب مقارنة هذا السلوك الأميركي الإجرامي تجاه عراق 2003 بالسلوك الروسي تجاه أوكرانيا هذه الأيام. فرغم استحالة تبرير لجوء روسيا إلى استخدام القوة، من الناحية القانونية على الأقل، إلا أنه يمكن على الأقل تفهّم دوافعه الأمنية، فضلاً عن أنه كان يمكن تجنّب الحرب أصلاً لو قبلت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لروسيا أو صرّحت علناً بعدم موافقتها على التحاق أوكرانيا بحلف الناتو.
يتّضِح ممّا تقدم أن القانون الدولي قابل للاستدعاء في الأزمات والمواقف الدولية في حالات مختلفة، لكنه موجود على الورق فقط، في غياب سلطة عليا قادرة على تطبيقه وفرض حمايته. وهذا وضع يغري كل من يملك القوة على استخدامها في كل مرة يتصور فيها أنه يستطيع أن ينجو بفعلته، رغم تحريم اللجوء إليها أو حتى مجرد التهديد بها تحريماً قاطعاً. وحين كانت الولايات المتحدة تهيمن منفردة على العالم، لم يكن بمقدور أحد غيرها استخدام القوة. أما الآن، وبعد أن وصلت الهيمنة الأميركية المنفردة إلى نهايتها، أصبح بمقدور غيرها استخدام القوة أيضاً، ما يوحي بأن النظام الدولي على وشك الدخول في مرحلة فوضى وعدم استقرار إلى أن يتم العثور على نقطة توازن جديدة.
القانون هو مظلة الضعفاء، أما القوة فهي أداة الأقوياء، لذا، لن يكون بمقدور المجتمع الدولي أن ينعم بالأمن والاستقرار ما لم يقرر الأقوياء في المجتمع الدولي إقامة نظام عالمي يضمن الأمن والاستقرار للجميع، الأقوياء منهم والضعفاء، أو بعبارة أخرى، إقامة نظام للأمن الجماعي يكون قابلاً للتطبيق، وهو ما لا يمكن أن يتم من دون إصلاح جذري للأمم المتحدة. وتلك هي “الفريضة” الغائبة الآن في المرحلة الراهنة من مراحل تطور النظام الدولي.